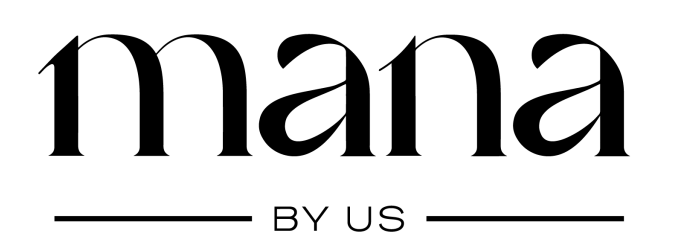قبل بَدء رحلتي الجدّية لتطوير ذاتي عن طريق الوعي والتشافي، كنتُ أعتقد أن التشافي يتعلّق أكثر بالمشاكل النفسية، أو أنه فكرةٌ غربيّة تمّ تسويقها لمن لديهم الكثير من المال، ويريدون تبذيره على ما يملأ الفراغ الذي يشعرون به في داخلهم وفي حياتهم. وما لم أكن أعلمه في ذلك الوقت، هو أن نظرتي التي أحكم بها على الناس بشكل عام، هي نتاج الفراغ الذي بداخلي أنا، وأن كلّ محاولاتي للحكم على محيطي أو تخطئته، ماهي إلا هرباً من المواجهة الحقيقية التي طالما تجنبتها، خوفاً من أن تتوجّه أصابع الاتهام باتجاهي.
استمرّ هذا الحال معي منذ اليوم الذي تخرجت فيه من الجامعة، واعتقدت فيه أنني أصبحتُ حرّاً، إلى بلوغي الثلاثين من عمري. فبعد عشرة أعوام من العمل بأقصى طاقتي، وبأقلّ وعي تجاه نفسي وألمي الذي أحمله معي إلى كل مكان، وجدت نفسي مرهقاً من الركض في نفس الدائرة، ووجدت أنني مهما تغيّرتْ ملامح الجدران أو وجوه الأشخاص من حولي، ما زلتُ أعاني نفس المشاكل التي تحدّ نموّي: عجزٌ، ثم ركودٌ، ثم غضبٌ، وامتعاض لحالي، يتجمّع ثم ينفجر ثم يعود ليتجمّع فينفجر. أصبحَ الغضب أحدَ سماتي الطبيعية، وبسبب قصور وعيي في ذلك الوقت، اعتقدتُ أنّ الغضب هو أمرٌ إيجابيٌ في حياتي، لأنني أحقق بعضاً مما أريد كلما انفجرت، بغضّ النظر عن الآثار السلبية التي تتركها هذه الانفجارات على عملي وعلاقاتي، وصحتي وحياتي على المدى الطويل.
في عيد ميلادي الثلاثين أتت لحظة المواجهة بحقائقها الواضحة التي تجاهلتها لسنين طويلة. لقد قررت أن أواجه نفسي بجرأة، ومع مواجهتي أتى التساؤل الأهمّ في حياتي: إن كانت الأحداث والعلاقات والمشاعر التي أحملها بداخلي تتكرّر بغض النظر عن المكان أو الأشخاص، فهل من الممكن أن يكون هذا التكرار من صنعي؟ هل من الممكن أن أكون أنا السبب في العذاب الذي أعيشه بيني وبين نفسي؟ هل من الممكن أن أكون أنا من يغذّي العجز الذي أشعر به في داخلي؟ هل أنا حقاً ضحيّة المنظومة التي خلقتُ ضمنها؟ أم أنني أنا المسؤول عن شكل ومعطيات هذه المنظومة؟ أتت ساعة الحقيقة في مواجهتي، وأدركت أن الأنماط المتكررة هي من صنعي، وأنني إن لن أخدع نفسي وأمارس هروبي، أنا صانع الحكاية، وأنا راويها، وأنا مدمرها ومحييها، إن أردتُها قحطاً سكنتْ جفافاً، وإن أردتُها خصباً انهمرت مياهاً. وبهذا اتخذت أول قرار حقيقيّ تجاه نفسي، بالوعي الذي تكوّن مع تساؤلاتي الصارمة تجاه نفسي، بدأتْ ترتسم أمامي ملامح التغيير الذي طالما حلمت به، ولم أستطع الوصول اليه لأنني في كل فرصة أتتني، كنت أبتدع الحجج لكي لا أخوض التجارب، وكنت أهرب من الفعل إلى الشكوى لنفسي عن سوء حظي وقلّة حيلتي.
عرفت أنني رغم اعتباري ناجحاً مادّياً واجتماعياً حسب المنظومة المتعارف عليها للنجاح، إلا أنني كنتُ بعيداً كل البعد عن نفسي. لم أكن أعرف مصدر غضبي وأثره على حياتي، لم أكن أعلم أنّ ما اعتقدتُ بأنه واقعي هو فعليّاً نسج من خيالي، ليس لأنني مجنون أو مختلّ عقلياً، ولكنْ لأنني مثل معظم البشر لم أكن أعلم أن القصص التي تتراءى لي في مخيّلتي هي انعكاسٌ لما مررتُ به من تجارب قاسية، وأحداثٍ اضطررت للتأقلم معها في طفولتي، وفي نموي، وقد تبرمجتْ بداخلي وأصبحتْ جزءاً من هويتي، أو بما كنت أعتقد أنه هويتي. في تحليلي لمشاعري وجذورها اكتشفت أنني أنا من يغذّي حالة الحزن والخذلان في حياتي، واكتشفت بالمقابل أنني، إن كنتُ أنا من يصنع الأسى، فإنني إذاً قادر على إيقافه، وقادرٌ على تغيير واقعي. وفي هذه اللحظة التي تحمّلت فيها المسؤولية التامة عن كل ما يحدث في حاضري من أحداث وعلاقات ومواقف مؤلمة، وعن كلّ ما يجول بداخلي من مشاعر انكسارٍ أو عدم ثقة أو غضبٍ؛ استطعتُ لأوّل مرة أن أخرج من لعب دور الضحيّة في مسلسل حياتي. ولأول مرّة أصبحتُ أنا الكاتب والمخرج لرواية حياتي، ولأوّل مرّة أحسست أن نجاح هذه الرواية يعتمد على الخطوة التي أخطوها أو لا أخطوها تجاه نفسي. ومع الوقت وبشكلٍ طبيعي بدأتُ باختيار شخصياتٍ وأحداث جديدة في حياتي؛ أعدتُ لنفسي دور البطولة مع إدراكي التام بأن الألم سيكون دائماً في خلفيات فصول روايتي والبطولة هي بمواجهة الألم وفهمه. أصبح ألمي معلّمي بدل أن يكون المدمر في لا وعيي. وهنا أخيراً استوعبت بأن التشافي هو ليس حبّة دواء أو مسكّن، التشافي رحلةٌ لا متناهية نختارها في كل يوم لنعرفَ المزيد عن أنفسنا. وكلما عرفنا أكثر كلما أحيينا أنفسنا أكثر.